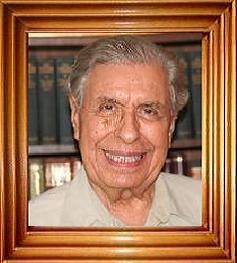في ذكرى الثورة العربية....
- التفاصيل
- تم إنشاءه بتاريخ الإثنين, 19 كانون2/يناير 2015 21:00
- كتب بواسطة: علاء الدين الأعرجي
علاء الدين الأعرجي
محام/ مفكر وباحث متخصص في التطور الحضاري
في ذكرى الثورة العربية: نستعيد ذكرى وثبة الشعب العراقي الكبرى، عام 1948أشجان ومفارقات مُلهـِمَة ومؤلـِمَة؛والطائفية مرفوضة
(ملحوظة: أعتذر إن كانت هذه المادة مُعادة بالنسبة للبعض، لأنها منشورة سابقا، غير أنني أقصد بها الأخوة الذين لم يطلعوا عليها بعد، ويمكن نشرها بشكل حلقات منفصلة، أو متصلة)
الحلقة الأولى
الذكرى الرابعة للثورة العربية(الربيع العربي) تثير أشجاناً عميقة وذكريات عزيزة، مؤلـِمَة ومُلهِمَة، لاسيما لأنها تشبه، مع الفارق، وثبة العراق الكبرى في عام 1948، التي استمرت من 4كانون ثاني إلى 27منه. أي يصادف تاريخها بل يتداخل مع الثورة التونسية والثورة المصرية،(2011) اللتين أسقطتا إثنين من أقسىى وأخطر الأنظمة في الوطن العربي. بينما أسقطنا في تلك الوثبة معاهدة بورت سموث وحكومة صالح جبر، التي عقدت المعاهدة، بصرف النظر الآن عن مناقشتها في ضوء الأوضاع التي تلتها حتى اليوم.
كانت ثورة شعبية بكل المقاييس، إذ واصلت الجماهيرالغاضبة تظاهراتها السلمية طوال شهر تقريبا. وخلالها تحولت إلى مجازر دامية سالت فيها الدماء الغزيرة، لاسيما من جانب زملائي الطلاب العُزّل إلا من الحجارة، من أهمها؛ واقعة الكلية الطبية ومعركة كلية الهندسة ومعركة الجسر(جسر الشهداء) ومعركة باب المعظم. وحدث في أثنائها عصيان عام أغلقت خلاله جميع المرافق العامة والخاصة. وسقط في هذه التظاهرات المئات من الطلبة والمواطنين العاديين، بين قتيل وجريح، نتيجة استخدام الذخيرة الحيّة من جانب شرطة النظام، ومن بين الضحايا الذين نعرفهم : قيس الألوسي وشمران العلوان وجعفر الجواهري والحمّال دحام .
و كان لي، وأنا في مرحلة الدراسة الثانوية، شرف المشاركة في جميع الأيام الحاسمة والدامية للمعركة. وقد شهدت سقوط بعض الزملاء المتظاهرين، كان أحدهم يتقدم خلفي مباشرة.
الحلقة الثانية
أزيز الرصاصة القاتلة
مع بضعة أفراد من الطلبة، كنت أحاول كسر الحصار الذي ضربته الشرطة على الساحة المقابِلة لمدخل الكلية الطبية، المفضية إلى الشارع العام ، وذلك للوصول إلى ساحة باب المعظم للنفاذ منها إلى شارع الرشيد، باعتباره أهم شوارع العاصمة. للخروج في تظاهرة سلمية، نعلم أنها وإن بدأت بالعشرات، ستفضي إلى الآلاف.
وأتذكر جيدا ً أنني وبعض الزملاء أخذنا نهدم السياج الخارجي للكلية بعد أن نفدت عدتنا من الحجارة القليلة التي نحتاجها لنقذف بها قوات الشرطة المدججة بالأسلحة والسيارات المدرعة التي نصبت فوقها الرشاشات. وكنا نقذف الحجارة، والرصاص يلعلع فوق رؤوسنا.
ما يزال أزيز الرصاصة التي أخطأتني، يرن في أذني، وكأنني على موعد معه في مثل هذه الأيام من الشهر الأول من كل عام، منذ قرابة سبعين عاماً. وأتذكر بوضوح أنني كنت أول المتقدمين وأكثرهم تقحما ً وحماسة ً، لكسر الحصار فتجاوزت السياج وأصبحت في منتصف الشارع العام تقريبا مع واحد أو إثنين من الطلبة، وبيني وبين خط الشرطة بضعة أمتار. وفجأة وجدت عيني تلتقي بعين أحد أفراد الشرطة وقد أصبته إصابة خطرة. وكانت الدماء تسيل من رأسه فتغطي كامل وجهه تقريبا ً. رأيته والشرر يتطاير من بقايا عينيه، وهو يصوب بندقيته نحوي، فأيقنت أن هذه نهايتي. ودوت الرصاصة القاتلة، التي مرت من طرف أذني اليسرى فأصابت رأس زميلي الذي كان يتبعني مباشرة؛ ورأيت رأسه يتفجر وهو يهوي على بلاط الشارع . أقول؛ ما يزال ذلك الأزيز الصارخ والقاتل يعصف في أذني، ويثير في أعماقي مشاعر يختلط فيها القدر والإرادة العلوية والمصير المحتمل أوالمحتوم، فضلا عن تساؤلات مرهِقة ، في سرّ الوجود وسر الموت والتطلع نحو الخلود. وأتسائل هل أخطأتني تلك الرصاصة عمدا ً أو صدفة ً، لتستقر في رأس صاحبي الشهيد الذي كان يتبعني مباشرة، فكتب الله ليّ الحياة وكتب له الموت، الذي كان بيني وبينه ربما أقل من شعرة؟ وهل أنا أسعد منه حظا أم العكس هوالصحيح ؟ وما الفرق بين ان يـُقتل الإنسان أو يستشهد قبل العشرين أو يموت في الثمانين، إذ "كل نفس ذائقة الموت"؟ " ويقول الشاعر "ومن لم يمت بالسيف مات بغيره ---- تعددت الأسباب والموت واحدُ". وهل أكرمني الله بهذه المِنـّة أو عاقبني ؟ أليس من الأشرف والأكرم والأسمى أن يموت الإنسان واقفا ً شامخا ً مكافحا ً في سبيل إعلاء كلمة الحق، من أن يقضي نحبه، ضعيفا ً مريضا ً مستلقيا ً على فراش الموتً، وهو في أرذل العمر؟ أي "يقضي على فراشه كما يموت البعير ،فلا نامت أعين الجبناء"، كما يقول خالد بن الوليد. وماذا جنيت فعلا ً من هذه الأعوام السبعين الزائدة التي عشتها؟ وإنْ لم أجنِ منها شيئا ً، على الصعيد الشخصي، فهل استفاد مني بلدي أو مجتمعي أو قومي أو البشرية، ما يكفي، لتبرير بقائي على قيد الحياة كل هذه السنين؟
الحلقة الثالثة
(أعتذر لاستخدام تعابير طائفية لم نكن نتداولها أصلاً)
القضية الطائفية لم تكن مطروحة بل مرفوضة ومن جهة أخرى، فإن أهمية التذكير بهذه "الوثبة" والتعبير عن بعض جوانبها، على الصعيدين الشخصي والتاريخي، ينبثق من كونها تعتبر مثالا ً جليـّا لتقييم الزعيم أو القائد السياسي، بناء على إخلاصه منجزاته وتاريخه وتطلعاته ومشاعره القومية والوطنية، وليس بناء على انتمائه الطائفي، في أي حال من الأحوال.
ولئن نستعيد أحداث تلك الفترة ونستذكر بعض الأمثلة، فإننا نلاحظ أن المسألة الطائفية لم تكن مطروحة أصلا. فرئيس الوزراء، صالح جبر، الذي يمثل أول رئيس وزراء شيعي تسلم الحكم بعد مرور قرابة ثلاثة عقود على إنشاء الحكم الوطني في العراق، فرفضه الشعب العراقي بأجمعه، مع أن الشيعة يشكلون النسبة الأكبر.
وقد كان الشاعر العراقي الكبير محمد مهدي الجواهري، وهو من أسرة شيعية عريقة، من أشد المحرضين على إسقاطه بقصائده التي تلهب مشاعرالمتظاهرين. وقد استشهد شقيقه جعفر برصاص شرطة صالح جبر، فرثاه بقصيدة عصماء تجاوزت المائة بيت، أثارت حماس الجماهير، مطلعها:
أتعلمُ أم أنت َ لا تعلم ُ بأن جـِراح الضحايا فم ُّ
يصيح على المدقعين الجياع أريقوا دماءَكمُ تـُطعموا
ويهتف بالنفر المُهطعين أهينوا لئامكم ُ تـُكرموا
(المهطعون : الذليلون )
ولهذه القصيدة التحريضية المثيرة دلالات مهمة، تكشف عن مدى رفض العراقيين للنزعة الطائفية. فالجواهري (الشيعي)، اختار أن يلقي قصيدته العصماء تلك في أكبر مسجد سني معروف بجامع الحيدر خانة. ولم يختر أن يلقيها في مسجد شيعي آخر. ولم يحصل أي اعتراض أو سؤال.
ومن جهة أخرى، فإن الأحزاب الوطنية المعارضة كانت تضم مختلف الطوائف والأديان، بما فيها الطوائف السنية والشيعية. كما يمثل كاتب هذه السطور، الذي ينتمي إلى أسرة شيعية محافظة، مثالا ً واقعيا ً حيا ً، لمدى تحرر الشيعة، من قياس الزعيم بمسطرة التشيع والتسنن، بل أن هذا الموضوع لم يكن مفكرا ً به أصلا ً.
وهذه الشذرات تعبر عما عاناه كاتب هذه السطور من صعاب، وما تعرض له من أخطار، أثناء تلك الوثبة، ثائرا ًضد صالح جبر، بصرف النظر عن شيعيتة، بسبب موقف الأخير المهادن للإنكليز. وقد حاول صالح جبر، في أواخر أيام الوثبة ، العزف على وتر كون التظاهرات التي انفجرت ضده، كانت بسبب انتمائه المذهبي، وذلك بقصد تحويل الشيعة، الذين كانوا يمثلون أكثرية االجماهير الثائرة، عن موقفهم المعادي له إلى موقف المؤيد له. ولكنه فشل في هذا المسعى. ففي الأيام الأخيرة للوثبة، أتذكر تماماً، أنني لاحظت، أثناء تظاهراتنا الصاخبة والدامية، وفي وقت أصبحنا فيه مسيطرين تماما ً على الشارع الأهم في قلب العاصمة، شارع الرشيد بكامله، أي من باب المعظم إلى الباب الشرقي، والذي خلا تماما ً من قوات الأمن والشرطة، بعد ان تركوا خلفهم عدة سيارات مدرعة محترقة ؛ لاحظت ظهور منشورات تشير إلى ذلك. فحرصنا على تمزيقها أو إهمالها، وكنت من أكثر المتحمسين لرفضها. ولم تؤثر هذه المحاولة الأخيرة في إنقاذ صالح جبر، مما اضطره إلى الاستقالة ، أو بالأحرى الإقالة ، فسقط في مساء 27/1/1948، لاسيما بعد "مذبحة الجسر" التي حصدت المئات من المتظاهرين.(لم يعرف عددهم بسبب التعتيم أو الإهمال، أو كلاهما).
وجدير بالذكر، أنه على الرغم من الغياب الكامل لقوات الأمن ، لم تشوه هذه الثورة أية عمليات كسر أونهب لأي من أهم الشركات والمحال التجارية الكبرى التي كانت تملأ شارع الرشيد، آنذاك. علما أن معظم تلك المحال المشهورة كانت مملوكة لجهات أجنبية أو يهودية أو مسيحية. وأذكر منها على سبيل المثال فقط: بيت لنج، وحسو أخوان، ونوفيكس، وكان المحل الأجنبي الشهير والمعروف بـ"أوروزديباك"،( عمر افندي) يقع في شارع النهر، ولكنه لم يصبْ بأي سوء. وكان من الممكن أن تتعرض هذه المحلات الكبرى، التي كانت تحتوي على خزائن من السلع الثمينة، للنهب بكل سهولة، لغياب قوات الأمن, ومن أهم الأحزاب السياسية الرافضة للمعاهدة هي: حزب الاستقلال، الذي يمثل أهم حزب عربي قومي، كان يرأسه الشيخ محمد مهدي كبه، وهو عميد أسرة "بيت كبة" الشيعية العريقة(علما أن مساعده الأقرب، هو صديق شنشل، كان سنيا ً، وهذا دليل آخر على ان هذا الموضوع لم يكن مطروحا ً أصلا ً) - والحزب الوطني الديمقراطي، يرأسه كامل الجادرجي، من أسرة سنية معروفة، (وكنا مع بعض الزملاء من قرائه) وحزب الأحرار وحزب الشعب والحزب الشيوعي العراقي، وهي أحزاب فيها خليط من الشيعة والسنة والمسيحيين وبعض اليهود، على السواء، دون أن تكون قضية التفرقة الطائفية أو الدينية مطروحة أصلا ً.
نعم، كنا نعلم نحن الطلبة أن تلك الأحزاب وقفت ضد إبرام المعاهدة وضد الحكومة، ودعت الجماهير إلى التظاهر لإسقاطهما؛ إلا أن معظم التظاهرات كانت عفوية، أكثر من أن تكون منظمة وموجهة سلفا. فجميع المظاهرات التي اشتركتُ، فيها، لم تكن فيها قيادات مقررة سلفاً، بل كنت أقود بعضها، مع أنني لم أكن سابقا(ولا لاحقاً) منتمياً إلى أي حزب سياسي. ومع ذلك كانت هناك توجيهات تنتشر بيننا بشأن مكان وزمان اللقاء في اليوم التالي مثلا.
وفي سياق النزعة الطائفية أيضا، أشير إلى أنني أوردت بعض الأدلة الواقعية الثابتة والصحيجة بشأن رفضها من جانب الجميع (في الطائفتين) ، ولكنني أستدرك، كي أكون مخلصاً مع نفسي ومع القراء، فأقول، إن هذه النزعة يمكن أن أصورها كالجمرة الخبيثة التي كانت وما تزال، قابعة، تحت الرماد الكثيف أو الخفيف؛ فهناك أحيانا ً من يؤججها، جهلا ً أو عمدا ً، خدمة لأغراض شخصية أو عقائدية، أو خارجية تخدم "الآخر". وهي تمثل اليوم أداة يستخدمها الآخر(إسرائيل/ أمريكا) لتحقيق أهدافه أو لمجرد بث الفتنة لإنهاكنا وزيادة تخلفنا بغية السيطرة على مقدراتنا . أما أصولها التاريخية، فمعروفة إلى حدّ كبير، بيد ان جذورها السحيقة، ربما تكون غامضة، بالنسبة للكثير. لذلك حاولت بحثها في كتاب "أزمة التطور الحضاري في الوطن العربي بين العقل الفاعل والعقل المنفعل"، وكذلك في كتابي الصادر مطلع هذا العام(2015) "الأمة العربية بين الثورة والانقراض" .
الحلقة الرابعة
ذكريات ومفارقات شخصية
في معظم تلك الأيام العصيبة والمثيرة، التي منع فيها منع التجوال، كان كاتب هذه السطور يخرج من بيته، الذي يقع في الحي السكني الهادئ جدا ً في ذلك الوقت؛ الكرادة داخل (شارع هويدي)، والذي كان يعتبر بعيدا عن مركز بغداد (أصبح اليوم جزءا من المركز، وحدثت فيه غالبا كثير من التفجيرات)؛ أقول، يخرج متلصصا، قبيل بزوغ فجر، كل يوم من الأيام الحاسمة للوثبة. وأحيانا يلقي نظرة دامعة على أخواته المستغرقات في أحلامهن، ويتوقع أنها قد تكون النظرة الأخيرة . ولا ينسى أن يحمل في جيبه شيئا من كسرات الخبز "البايت" أو الجاف، (من جوة النجانة: طست كبير مقلوب على طبق أكبر من القش، حيث المكان الذي كنا تحفظ فيه بقايا الخبز)، وبعض التمرات الجافة (أرخص أنواع الزهدي الجسب) ، وكتاب مدرسي للتمويه، ليبدأ رحلته الخطِرة والمرهِقة على الأقدام، التي تتجاوز الساعتين، متخفيا بين الأحراش، والأشحار الباسقة في بساتين "الكرادة" الكثة وخلف جذوع النخيل التي كانت تملأ المنطقة، كلما لمح عن بعيد مفرزة شرطة تحفظ أوامر منع التجوال المشددة. وإذا وصل مركز المدينة، بعد الباب الشرقي، فإنه يتحاشى الشوارع الرئيسية، فيتسلل عبر"الدرابين"، أي بين الأزقة الأثرية الضيقة في أحياء بغداد العتيقة، التي كانت خالية من المارة على غير العادة، ومنها،الحيدرخانة وسيد سلطان علي وباب الشيخ والصَدرية والدهانة والسويدان وعقد النصارة والشورجة فحي الميدان، متوجها ً إلى حي المعاهد العالية في الباب المعظم. وهكذا يتجنب دوريات الشرطة الراكبة والراجلة، التي كانت منتشرة في جميع الطرق الرئيسية والساحات العامة لتفعيل منع التجوال.
الحلقة الخامسة
القبض عليه متلبسا ً بجريمة خرق الأمن
ومع ذلك لم ينج ُ هذا الولد العاق من ملاحقة شرطة النظام. ففي بعض المرات قبضوا عليّه متلبسا بجريمة انتهاك "حُرمة" أوامر منع التجوال. فيقول للشرطي ببراءة : "عمي، آني رايح والله البيتنة، بعكد السويدان، جنتْ ابيت صديقي "محمد" دندرس للامتحان" وأعرض كتاب الفيزياء الجاهز تحت أبطي. (أي: إنني عائد إلى بيتنا في حي "السويدان"، وكنت مع صديقي "محمد" نحضر للامتحان ). ويتغير تحديده لحي إقامته، الكاذب، تبعا لمكان إلقاء القبض عليه.
وفي إحدى المرات الحاسمة، وجد نفسه وجها لوجه أمام ضابط شرطة عملاق، أخذ بتلابيبه بعنف ورفعه عن الأرض، فشهقَ من الهلع، وحاول أن يصرخ دون جدوى، وهذه الأصابع الجبارة تطبق على عنقه بقوة، فحشرجَ وهو يختنق، وذكر الله وتشهد في سره، لأنه شعر أن نهايته وشيكة . ولكن فجأة يتوقف هذا المارد ويفك عنه قبضته القوية وهو يُحَمْلِق في وجهه، ويهتف قائلا: "علاء ابن الأستاذ السيد صادق ؟ ويأخذه بين يديه برفق ويجلسه على "دكة" على قارعة الطريق، والصبي يَسعل بشدة ويشعر وكأن صدره يتمزق، وأمعاءه تصعد إلى حلقه، وهو يتحسس عنقه، ولا يصدق أنه تخلص من قبضة هذا الجبار اللعين. وضابط الشرطة يطمئنه ويحاول أن يسقيه ماءً من "مُطارتة"(ترموس بدائي). وبعد أن هدأ من روعِه قليلا ً ، تجرأ الصبي فرفع ناظره إلي ضابط الشرطة ، فعِرفه: أحد أبناء الفلاحين الطيبين من سكان "الكرادة" الأصليين، الذين كانوا يحرصون على زيارة والد الصبي لتقديم التمنيات في أعياد الفطر والأضحى، ويتمتعون بأحاديثه التاريخية والدينية الشيقة، وكان الصبي يقدم لهم الحلوى أو الشاي و"الكليجة" العراقية اللذيذة، المحشية بالتمر أو بالجوز واللوز مع السكر( كعك العيد). التي تصنعها وتخبزها والدتي بـ"التنور"، فنساعدها، أخواتي وأنا، في عجن العجين بالدهن البلدي الحرّ، في "طشت" شاسع، طوال الليلة التي تسبق العيد بعدة أيام. وكان هذا الشرطي / الصبي، يحضر غالبا مع والده فيقدم له علاء "شربت" شراب البرتقال اللذيذ، بدل الشاي، مع قطعتين كبيرتين من الكليجة. وكان يكبرني عدة سنوات، سمعت أنه دخل مدرسة الشرطة بعد الصف الثالث المتوسط، فأصبح ضابط شرطة يحترمه الفلاحون.
والأهم أن "الولد" الشقي علاء أصبح مطلق السراح ،فتنفس الصعداء وحـَمَدَ الله على السلامة، بل انتعشَ وانتفشَ، حين اعتذر منه الضابط بكل أدب وأسف أمام أفراد الشرطة الاخرين، وأردف قائلا ً:" والله آني ما اعرفتك، عبالي واحد من ذولة المخربين اللي يردون يسوون مظاهرات". لكن الضابط استدرك، وفاجأ الصبي بسؤال أحرجه قائلا : "لكن أنت وين رايح بعيدا ً عن بيتكم في هذا اليوم العصيب ؟". وهنا أخذ الصبي كتابه، واستجمع ما تبقى من شجاعته، وانتصب قائما ً، وقال له بكل تحد ٍ وكبرياء وبلاغة، وهو يبتعد بسرعة: "أنا سأقوم بواجبي الوطني النبيل ، وأنت مضطر للقيام بواجباتك القذرة". وأطلق ساقيه للريح، قبل إنهاء عبارته الأخيرة، والشرطي يصرخ :عـُدْ من حيث أتيت، فلدينا تعليمات مشددة بمنع التظاهرات بأي ثمن، وإلا سألقي القبض عليك . . . .". لكنه كان قد أبتعد كثيرا ً قبل أن ينهي كلماته، مستغلا ً تسامُح هذا الشرطيّ الطيبْ، الحائر، بين تطبيق الأوامر، والمحافظة على قيّم "العقل المجتمعي"العربي/ العراقي الأصيل، التي تفرض عليه احترام هيبة السلطة الأبوية والجيرة والعلاقة الطيبة، ومتأسيا ً بقول الشاعر:
إذا أنت أكرمتَ الكريم َ مَلكـتـَهُ وإنْ انت أكرمتَ اللئيم تمردا .
فيديوات أيام زمان
من القلب للقلب
حكاية صورة
تراث وتاريخ
شخصيات في الذاكرة العراقية
أدب الرحلات
زمن الماضي الجميل
فى ربوع العراق
أفلام من الذاكرة
الطرب الأصيل
الأبراج وتفسير الأحلام
المتواجدون حاليا
692 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع
اخر الاخبار
- كلمات على ضفاف الحدث : العراق الجديد وحزن البسطاء من الاهل
- أغنية رمضان جانا - محمد عبد المطلب
- الوقف السني وأوقاف إقليم كوردستان يعلنان الأربعاء أول أيام رمضان
- تهاني وتبريكات لمناسبة حلول شهر رمضان
- حرب الاستطاعة ايران - اسرائيل من يستطيع؟ ومن لا يستطيع
- مقارنة بين طاقة السعادة وطاقة البؤس !!!
- الندوة القانونية :تحت عنوان العدوان الأميركي– البريطاني على العراق (٢٠٠٣) بوصفه انتهاكا ً لميثاق األمم المتحدة
- بين فنجانٍ وضحكة … يولدُ الضوءُ في الرصيف
تابعونا على الفيس بوك