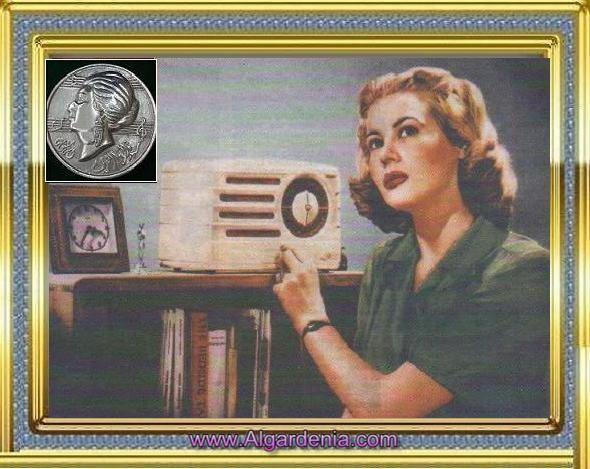طقوس المشاعر بين الخصوصية وفرض الهوية حين تتحول شعائر احياء المقاتل إلى هيمنات ثقافية
- التفاصيل
- تم إنشاءه بتاريخ الجمعة, 01 آب/أغسطس 2025 12:26
- كتب بواسطة: ذو النورين ناصري زاده
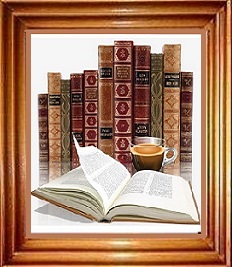
ذو النورين ناصري زاده
طقوس المشاعر بين الخصوصية وفرض الهوية حين تتحول شعائر احياء المقاتل إلى هيمنات ثقافية
في قلب المشهد العراقي المتشظي، وفي عمق نسيجه الذي تتنازعه الانتماءات الدينية والعرقية والمذهبية، تبرز إشكالية معقّدة ومزمنة: كيف يمكن للتدين أن يكون ممارسة خاصة وهادئة، لا أداة صراع ولا راية للغلبة الرمزية والسياسية؟ كيف نمارس طقوسنا وشعائرنا بكرامة دون أن تتحوّل هذه الممارسات إلى أدوات ترهيبٍ واستفزاز، أو شعورٍ بالقوة على حساب شعور الآخر بالانتماء؟
إنّ الطقس الديني في جوهره الأصيل، هو حالة وجدانية خالصة، تسكن وجدان الإنسان، وتعبّر عن ارتباطه الروحي بما يؤمن به. هو طقسٌ وجداني يتوارثه الأبناء من الآباء، ويتحوّل مع الزمن إلى جزء من هوية الفرد، وعصبٍ من أعصاب ذاكرته. لكنه في السياق العراقي الحديث، لا سيما بعد 2003، غادر هذه المساحة الداخلية الحميمة، وتحوّل في كثير من الأحيان إلى سلوكٍ جماعي ذي طابع استعراضي صدامي، يعيد تشكيل المجال العام، بل ويعيد ترسيم حدود الجغرافيا بالهتاف واللطم والدخان والرايات.
لقد تجاوزت الممارسات الطقوسية حدودها التعبدية، إلى أن أصبحت، أحياناً، فعلاً سياسياً مموّهاً، يستعرض القوة والهيمنة، لا الحزن والتقوى. باتت بعض الشعائر الدينية أدوات لإعادة ترسيم الخرائط النفسية والثقافية، ورسائل غير معلنة مفادها: "نحن هنا"، لا كمجرد حضور اجتماعي، بل كقوةٍ سائدة تُعيد ترتيب الأولويات والولاءات.
انظروا جيداً إلى ما جرى في مدنٍ مثل تكريت والموصل وحديثة وكركوك والدور وبيجي. تلك الحواضر التي تمثّل روح المكون السني العراقي، بهويته الفقهية والثقافية الممتدة قروناً في الزمن. حين تدخلها مواكب عاشوراء برفقة عناصر مسلّحة، أو بغطاء سياسي معلن أو غير معلن، فهي لا تأتي بصفاء النية ولا بطابعها الديني المحض، بل كقوة ضاغطة تستحضر الماضي لصياغة الحاضر على نحو إقصائي. ليس الأمر مجرد شعائر، بل إعادة إنتاج للفضاء العام وفق هوية طائفية مهيمنة، تُقصي المختلف وتجعله يشعر بالغربة داخل بيته.
هذه الممارسات تُفضي إلى عنفٍ رمزيّ خفيّ، أخطر من العنف المادي. إذ تُخاطب وعي الناس ولا وعيهم في آن، فتبعث برسائل قسرية تُحاصر الذاكرة الجمعية لأهل تلك المدن، وتكسر انتماءهم الرمزي إلى المكان، وكأن المدينة تُنتزع منهم، ويُعاد تشكيلها بهوية ليست منها.
لكن هل هذا الخلل طارئ على المشهد؟ أم أنه نتيجة مسار طويل من التوظيف السياسي للدين؟
منذ عقود، وربما منذ تشكّل الدولة الحديثة في العراق، ظل الدين أداةً في يد السلطة أو المعارضة، لكنه لم يكن يومًا بهذا الحجم من التغلغل في الشأن العام، ولا بهذا القدر من القدرة على إعادة إنتاج الفضاء والوعي والسلوك. إن الذي جرى بعد 2003 لم يكن فقط صراع هويات، بل تفكك المرجعيات الكبرى التي كانت تضبط التوازن الرمزي بين مكونات الشعب العراقي.
لقد أسقطت الحربُ وسقوط النظام كل المحرّكات الكبرى التي كانت، وإن بشكل قسري، توازن بين المذاهب والطوائف. فملأت القوى الطائفية الفراغ، وحوّلت الطقوس إلى أدوات ترميز سياسي وجغرافي، تصاحبها، أو تسبقها، عمليات تغيير ديموغرافي وتحوير للهوية الثقافية العامة.
بل إنّ الخطاب الديني ذاته تحوّل، في كثير من الأحيان، من خطابٍ تعبّدي وعقلاني، إلى خطابٍ تعبوي حربي، يُنتج خصماً دائماً ويؤجج خطاب الثأر. والمؤسف أن هذا التحول وجد صداه في مؤسسات دينية كان يُفترض أن تشتغل على رأب الصدع، لا على تعميقه.
فهل نحن أمام تدين أم طائفية؟ وهل نحن أمام شعائر أم أدوات قهر ناعم؟
الأدهى من كل ذلك، أن ما يُروّج له من "حرية ممارسة الشعائر" الحسينية يتحوّل على الأرض إلى فرض قسري لتلك الشعائر، وإلى تآكل لخصوصيات الطوائف الأخرى. فالمشكلة لا تكمن في إقامة الشعائر بحد ذاتها، بل في فرضها في مناطق ليست بيئتها، أو في تحويلها إلى طقسٍ يملأ المدينة بكل ما تحمله من رموز، وأهازيج، ولافتات، وحشود، وتعبئة، كأن المكان يُستباح مرة أخرى، ولكن بلباس ديني.
كل مدينة عراقية لها ذاكرتها، ووجدانها الجمعي، وصورتها الروحية. الموصل ليست فقط مدينة سنية، بل هي ذاكرة عباسية، وشعر أندلسي، ونَفَس عثماني، وروح نبوية. كربلاء ليست فقط شيعية، بل هي أيضاً مشهد للبطولة والفداء الإنساني في وجه الظلم. برطلة ليست مجرد بلدة مسيحية، بل هي سردية من المحبة والسلام والتراتيل القديمة. وزاخو ودهوك ليستا فقط مدينتين كرديتين، بل هما نسيجٌ من الأسطورة واللغة والطبيعة.
فمن الظلم أن نقولب كل هذه الهويات، ونختزلها في ثنائية شيعي/سني، أو نختزل الدين نفسه في الطقس فقط. الدين ليس لطم صدور ورفع رايات، ولا شعارات حماسية تتحدى الخصم، بل هو، في جوهره، وعيٌ بالذات، ورحمة بالآخر.
فما الحل؟ الحل ليس في إلغاء الطقوس، ولا في منع الآخر من التعبير عن إيمانه. الحل يبدأ أولاً من وعي عميق بمفهوم "الخصوصية الجغرافية للهويات الدينية"، ثم يُبنى على قاعدة احترام التعدد لا اختراقه، وعلى قاعدة أن الطقس فعلٌ اختياري في بيئته، لا غزوٌ خارجها.
الحل في أن تتحرر الشعائر من وهم الاستقواء، وأن يتحرر المتدين من وهم "التمكين" عبر الموكب والصرخة والراية.
الحل في أن يتحول رجال الدين من أدوات صراع إلى صُنّاع سلم اجتماعي، يعيدون الاعتبار لقيم الدين في بعدها الإنساني الرحب، لا الطائفي الضيق.
إنّ إعادة تعريف "الحرية الدينية" باتت أولوية وطنية، لا فقط حقاً دستورياً. فحريتي في ممارسة شعائري لا تعني أن أمارسها على جراح الآخرين، ولا أن أختبر بها صبرهم وتسامحهم. كما أن حقّي في التعبير عن إيماني لا يعني أن أفرضه على غيري، بل أن أحترم اختلافه كما أطالب باحترام اختلافي.
العراق، هذا الوطن الموزايكي، إما أن يكون لكل العراقيين، أو لن يكون لأيٍّ منهم. فلا مجال لهوية واحدة تبتلع البقية، ولا لصوت واحد يخنق التعدد. إنّ التحدي الحقيقي هو: كيف نحوّل طقوسنا من أدوات توتر إلى جسور تعايش؟ كيف نُربّي أبناءنا على التدين الحميمي لا الصخب الجماعي؟
ذلك هو المعيار الفارق بين مجتمع يعيش الدين، ومجتمع يستهلكه. وبين وطن يتسع للجميع، وآخر تضيّقه الهويات الضيقة حتى يختنق.
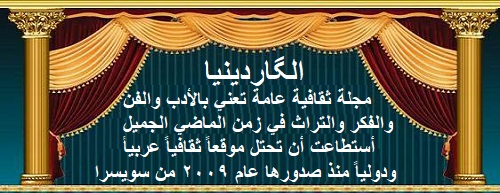
فيديوات أيام زمان
من القلب للقلب
حكاية صورة
تراث وتاريخ
شخصيات في الذاكرة العراقية
أدب الرحلات
زمن الماضي الجميل
فى ربوع العراق
الطرب الأصيل
الأبراج وتفسير الأحلام
المتواجدون حاليا
1137 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع
اخر الاخبار
- رفعت الأسد ... رحل مخلفاً تركة ثقيلة من الانتهاكات
- خاص - أزمة سيولة تربك صرف الرواتب لهذا الشهر
- القيادة الوسطى الأميركية: سننقل نحو ٧ آلاف عنصر من داعش إلى العراق
- سافايا: استعادة سيادة العراق تبدأ بتفكيك الفصائل ومواجهة الفساد
- "إذا حاولت اغتيالي".. ترامب "سنمحو إيران من على وجه الأرض"
- فيديو / الرئيس بارزاني يجتمع مع البابا ليو الرابع عشر في الفاتيكان
- صدام حسين في دمشق وأنقرة
- عندما تُسرَق الطفولة قبل أوانها - إلى بائع الشاي كرار الذي رحلَ قبل الأوان ...
تابعونا على الفيس بوك