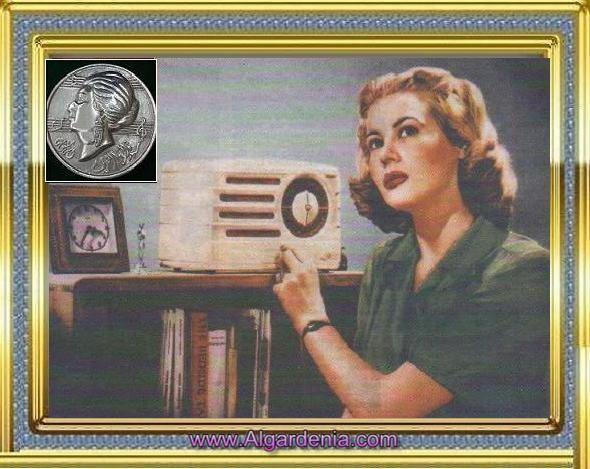العصبة الموالية: درع السلطة وسرّ تغولها او انهيارها قراءة تاريخية في دور الولاءات في تثبيت الأنظمة والحكومات
- التفاصيل
- تم إنشاءه بتاريخ الجمعة, 29 آب/أغسطس 2025 11:09
- كتب بواسطة: قلم باندان
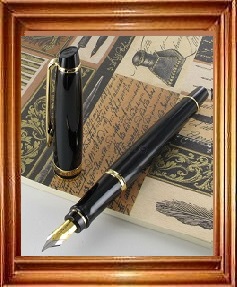
قلم باندان
العصبة الموالية: درع السلطة وسرّ تغولها او انهيارها
قراءة تاريخية في دور الولاءات في تثبيت الأنظمة والحكومات
منذ أن عرف الإنسان معنى السلطة، وهو يبحث عن سندٍ يتكئ عليه وقت العواصف، وعن عصبةٍ يلوذ بها حين تتزلزل الأرض من تحت قدميه. هذا ليس سلوكًا طارئًا، بل ناموسٌ في تاريخ الحكم والسياسة، لا تلغيه الحضارات، ولا تُبطله الدساتير. إنه تجلٍّ بشري لحكمة إلهية خالدة: وفي قوله تعالى للنبي الكريم أن يؤوي إلى "ركنٍ شديد"، تتجلى الفكرة المحورية: ضرورة وجود ولاء خالص لا يتزعزع حين تهتز الشرعية. وقد ترجمت الأنظمة هذا المعنى بصيغ متعددة عبر العصور الحديثة: من الحرس البرايتوري في روما، إلى الإنكشارية في الدولة العثمانية، إلى الموالي في العصر العباسي، وصولًا إلى نماذج معاصرة كالشركس في الأردن، والحشد الشعبي في العراق، والحرس الخاص في رومانيا.
اذ في ذروة مجدها، جسدت الدولة العثمانية نموذج "العصبة الموالية" عبر الإنكشارية أو "الجيش الجديد". وقد تأسس هذا الجيش من خلال نظام الدوشيرمة الذي جُنّد فيه أطفال مسيحيون من البلقان، انتُزعوا من أصولهم، وأُخضعوا لتربية إسلامية صوفية على الطريقة البكتاشية. وهكذا صُنع ولاء مطلق لا يعرف إلا السلطان. ولكن هذا الولاء لم يكن خاليًا من التوظيف المذهبي، إذ انطوت الطريقة البكتاشية على ميولٍ شيعية واضحة، وكان من أدعيتهم: "نادِ عليًا مظهر العجائب". ما يكشف كيف يُستثمر الدين والمذهب في صناعة ولاءٍ يتجاوز الهويات التقليدية. اذ أسهم الإنكشارية في توسع الدولة، لكنهم ما لبثوا أن تحوّلوا إلى قوة منفلتة، خلعوا 12 سلطانًا وقتلوا اثنين، حتى أصبحوا خطرًا على النظام ذاته. فكان لا بد من القضاء عليهم، وهو ما فعله السلطان محمود الثاني عام 1826 في "الواقعة الخيرية".
وقبل تجربة العثمانيين، لجأ الخلفاء العباسيون إلى الموالي (من المسلمين غير العرب، لا سيما الفرس والترك والديلم)، خصوصًا مع تراجع العصبية العربية التي قامت عليها. وكما لاحظ ابن خلدون، حين تضعف العصبية الأصلية للدولة، تُستقدم عصبية بديلة تحفظ التوازن. ففي البداية، شكّل الموالي ركيزة حيوية للدولة، لكنهم مع الوقت تغولوا على سلطة الخليفة نفسه، كما حدث في "فوضى سامراء" (861–870م)، حين بسط القادة الأتراك نفوذهم على البلاط، وبدأوا بعزل الخلفاء وقتلهم. فتحولت العصبة من أدوات طاعة إلى مراكز قرار مستقلة عن مؤسسة الخلافة.
في العصر الحديث، لم تتخلّ الأنظمة عن هذا النمط من الاستقواء بالعصبة، بل أعادت إنتاجه بأشكال طائفية أو أمنية أو عرقية، حسب مقتضى الحال:
أقلية عرقية متماسكة لعبت دورًا بارزًا في الحرس الملكي والمؤسسات الأمنية. العلاقة بين الشركس والعرش الهاشمي لم تكن مجرد تعيينات وظيفية، بل عقد ولاء تاريخي يجعل مصير الجماعة مندمجًا بمصير النظام. ورغم ما يحققه ذلك من تماسك داخلي، إلا أنه يطرح تساؤلات حول مبدأ المواطنة المتساوية.
وفي العراق نشأ من رحم الطائفية والفوضى بعد الغزو الأميركي، وبدأ كقوة مقاومة لـ"داعش"، لكنه تحوّل تدريجيًا إلى كيان سياسي-عقائدي يفوق في بعض الأحيان مؤسسات الدولة الرسمية. ولاؤه العقدي للمرجعية أو الزعامة الطائفية جعله ركنًا شديدًا موازٍ للدولة، لا تابعًا لها.
جاء ظهور الحشد الشعبي في العراق كاستجابة استثنائية لوضع استثنائي. ففي أعقاب الانهيار السريع للجيش العراقي أمام تنظيم داعش عام 2014، وانهيار الدولة في محافظات كاملة كنينوى وصلاح الدين والأنبار، شعر الشارع العراقي، خصوصًا في الوسط والجنوب، بغياب الحماية الرسمية، مما ولّد فراغًا أمنيًا قاتلًا لم يكن بالإمكان ملؤه بالوسائل التقليدية.
في هذا السياق، جاءت فتوى "الجهاد الكفائي" التي أصدرتها المرجعية الشيعية العليا في النجف، لتؤسس الإطار الديني والشرعي لتشكيل قوات الحشد. ومع الوقت، أصبح الحشد الشعبي ظاهرة مركّبة جمعت بين الشرعية الدينية، والحاجة الأمنية، والديناميات الطائفية، والحضور السياسي. وقد أُقرَّ وجوده رسميًا لاحقًا كجزء من القوات المسلحة العراقية، لكنه بقي كيانًا متمايزًا في بنيته وخطابه وولائه. وقد صاحب هذا التكوّن عدة ظواهر جديرة بالتأمل:
• تعدد الولاءات داخل الحشد: فبينما يدين جزء كبير منه بولائه للمرجعية في النجف، ترتبط فصائل أخرى بمرجعيات إقليمية، مما أدى إلى ازدواجية في المرجعيات وتباين في المواقف السياسية والعسكرية.
• صعود اقتصادي موازٍ: أنشأت بعض فصائل الحشد أذرعًا اقتصادية واسعة، تدخلت في قطاعات مثل التجارة، والبناء، والنفط، وحتى التهريب عبر المنافذ الحدودية، مما خلق منظومة نفوذ خارج الرقابة المؤسسية.
• تغلغل سياسي: تحوّلت بعض فصائل الحشد من مجرد "أذرع قتالية" إلى كيانات سياسية تمتلك كتلًا برلمانية وتحالفات انتخابية، مما زاد من اختلاط الوظيفة الأمنية بالوظيفة السياسية، وأربك المشهد الدستوري للدولة.
• تغيير في العقيدة الأمنية للدولة: إذ لم يعد مركز القوة والسيادة محتكرًا من قبل الجيش أو الحكومة المركزية، بل بات موزعًا على مراكز قوى تتشارك أو تتنازع شرعية القرار الأمني والسياسي.
كل هذه المؤشرات تُظهر أن الحشد، وإن كان قد وُلد من لحظة وطنية ودينية لحماية الدولة، إلا أنه مع مرور الوقت، تحوّل إلى ركنٍ شديدٍ موازٍ للدولة، لا جزءًا منها. بل إن وجوده نفسه أعاد تعريف مفاهيم مثل "الشرعية" و"المؤسسة"، وأدخل العراق في تجربة معقدة بين حماية الدولة وتحديها في آنٍ واحد. وهنا، يظهر السؤال الجوهري: هل العصبة الموالية تنقذ الدولة، أم تؤسس لنموذج موازٍ يتفوق عليها؟
في البداية، نشأ الحشد الشعبي كاستجابة طارئة لتهديد وجودي متمثل في تنظيم داعش، وكان هدفه الأساسي حماية العراق واستعادة سيادته من خطرٍ خارجي مباشر. لكن مع مرور الوقت، أخذ الحشد مسارًا مختلفًا، تحوّل من مجرد قوة مساندة إلى لاعب رئيسي يهيمن على المشهد السياسي والأمني. هذا التحول جاء نتيجة مجموعة عوامل وأسباب:
• دعم خارجي وتبني إقليمي: تلقى الحشد الشعبي دعمًا واسعًا من قوى إقليمية، وعلى رأسها إيران، التي رأت فيه أداة لتعزيز نفوذها في العراق والمنطقة، مما أعطى بعض فصائل الحشد قدرة على التمويل المستمر والتسليح المتطور، بعيدا عن رقابة الدولة.
• تمدد النفوذ السياسي: استثمرت الفصائل داخل الحشد تواجدها العسكري في توسيع وجودها السياسي، عبر تشكيل أحزاب وكتل برلمانية قوية، فصارت هذه الفصائل تتحكم في مفاصل الدولة التشريعية والتنفيذية، بل وتفرض أجنداتها على الحكومات المتعاقبة.
• التمرد على المؤسسات الرسمية: في كثير من المناسبات، رفضت بعض الفصائل الانصياع لأوامر الحكومة، بل ورفضت حتى دمجها الكامل في هيكل الجيش الرسمي، مما خلق مؤسسات أمنية موازية تتصرف باستقلالية شبه تامة.
• الموارد الاقتصادية: سيطرة بعض الفصائل على مناطق استراتيجية ومصادر دخل اقتصادية سمحت لها بتمويل ذاتي دون الاعتماد على الدولة، مما عزز من استقلاليتها وأدائها دورًا يفوق المؤسسة الحكومية.
• استقطاب الولاءات العقدية والعرقية: أعاد الحشد إنتاج الولاءات الطائفية والعشائرية، فبات ولاؤه مقترنًا بمرجعيات دينية أو زعامات محلية، وليس بالدولة كمؤسسة جامعة، مما قاد إلى تعميق الانقسامات بدلاً من التوحد.
هذه العوامل مجتمعة قد أفضت إلى وضع معقد، حيث صار الحشد الشعبي قوة موازية تمارس نفوذًا سياسيًا وعسكريًا أحيانًا يفوق نفوذ الدولة نفسها. وهكذا، تحوّل "الركن الشديد" الذي يفترض أن يحمي الدولة، إلى ركن يشكل تحديًا للمؤسسات، ويهدد استقرارها وسيادتها.
وفي رومانيا أسّس نيكولاي شاوشيسكو جهازًا نخبويًا تحت مسمى "الحرس الخاص"، تمتع بصلاحيات واسعة لحماية الزعيم والنظام، لا الشعب أو الدولة. لكن حين اندلعت الثورة الشعبية في ديسمبر 1989، انهار الحرس كما انهار شاوشيسكو، بعد أن تخلت عنه الجماهير. فانهار الركن حين انفصل عن الأرض التي تحته.
وتشير النماذج القديمة والمعاصرة إلى حقيقة جوهرية:
قلق السلطة أبدي، وولاء العصبة لا يدوم. فحين يرتكز الحكم على ولاءات خاصة بدلاً من شرعية عامة، يتحوّل "الركن الشديد" إلى عامل تآكل، لا صمود. العصبة قد تحمي الرأس، لكنها تنهك الجسد، وتقوّض الدولة من الداخل.
التحول المطلوب ليس في إنتاج عصبة جديدة، بل في بناء دولة قوية، تكون هي الركن الحقيقي لكل المواطنين. دولة تقوم على العدالة، والدستور، والشرعية الشعبية، لا على الولاءات الخاصة أو العصبيات الطائفية ,والعنصرية
وفي كل مرة تحتمي فيها السلطة بعصبة مخلصة بدلًا من شعب واعٍ ومؤسسات عادلة، فإنها تغرس بذور فنائها بيدها.
فالعصبة، مهما بلغت من الشراسة، لا تُغني عن العدل، ولا تصنع مشروعًا وطنيًا جامعًا.
إنّ "الركن الشديد" ليس من يحمل السلاح، بل من يحمل الثقة.
و"العصبة الحقيقية" ليست من تلتف حول الزعيم، بل من تلتف حول القانون.
الدولة التي تستبدل مواطنيها بأتباع، ومؤسساتها بعصبيات، سرعان ما تكتشف أن الجدران التي بنتها لتحمي نفسها... كانت في الحقيقة أسوارًا تحاصرها.
والتاريخ، في جميع محطاته، لا يُبقي إلا دولة واحدة:
دولة العدالة.
أما سائر العصبات... فهي إلى زوال.

فيديوات أيام زمان
من القلب للقلب
حكاية صورة
تراث وتاريخ
شخصيات في الذاكرة العراقية
أدب الرحلات
زمن الماضي الجميل
فى ربوع العراق
أفلام من الذاكرة
الطرب الأصيل
الأبراج وتفسير الأحلام
المتواجدون حاليا
1538 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع
اخر الاخبار
- عبد اللطيف التلباني ...أغنية قصيرة لم تكتمل فصولها
- تنويه الى الأخوة والأخوات كتاب وقراء مجلة الگاردينيا المحترمين
- يوم ٨ شباط ١٩٦٩ في ذاكرة الدورة ٢٣ كلية الشرطة
- برنامج سيرة من بلادي - أفلام الزمن الجميل
- قصة الخليقة في العهد البابلي القديم
- أخر نكات الشارع العراقي!!.
- حين يرفض الرئيس الرحيل: قصة براقش العصر الحديث
- السيدة السعيدة
تابعونا على الفيس بوك