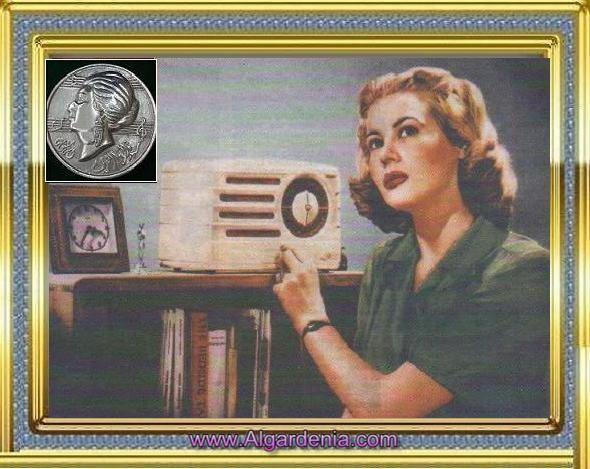سايكس-بيكو العشائرية: الأحساب بين انتماءات تتغير وانساب تتبدل
- التفاصيل
- تم إنشاءه بتاريخ الخميس, 21 آب/أغسطس 2025 15:30
- كتب بواسطة: ابراهيم فاضل الناصري

إبراهيم فاضل الناصري
سايكس-بيكو العشائرية:الأحساب بين انتماءات تتغير وانساب تتبدل
بين وثائق تُعدَّل وأعراف تُتَّبع، وتقاليد تتوارى تحت وطأة المصالح، وفي مجتمع تتشابك خيوطه بين الرحم والمصلحة، يتكشف في تكريت، كما في غيرها من المدن، مشهدٌ غريب ولافت: موجة متصاعدة من تبدّل الانتماءات العشائرية وإعادة ترتيب الألقاب والأحساب، كأن الهوية صارت نسيجًا قابلًا للتفصيل بحسب الطلب أو الحال، أو ورقة يُمزّقها الزمان ويُعيد لصقها بألوان أخرى وفق مقتضيات اللحظة. فمن كان ناصريًّا في حسبه يخلع عباءة ناصريته ليصبح تكريتيًّا بحتًا في لقبه وحسبه، ومن كان تكريتيًّا في حسبه الحمائلي يُلبس نفسه ثوب السيدوية فيخلع لقب التكريتي ويضحى يلقب نفسه بالرفاعي او الهاشمي، ومن كان لقبه وحسبه الحديثي يتحوّل إلى عبيدي أو شمري أو او ... في لقبه وفي حسبه. كما ان من كان مشهورا في كونه ناصريا في الحسب يضحى ناصريا في النسب وليست هذه حالة استثنائية فردية أو عائلية، بل انها موجة تتغلغل في البنية الاجتماعية التكريتية، فتفتح فصلاً جديدًا من التساؤلات: أين يقف الرحم حين تتقدّم المصلحة؟ وأي معنى تبقى لهوية تُبنى على ورقٍ قابل للتغيير؟
إنّ المتأمل يجد أن هذه التحولات ليست عبثًا عابرًا، بل نتاج تداخل السياسة والاقتصاد والنفس الاجتماعي. فقد تغيّرت خريطة النفوذ بعد عام 2003، وأصبح الانتماء العشائري، لا سيما في بعض المناطق، سلطة واقتصادًا وحماية، حتى صارت الأنساب بطاقات عبور للسلطة أو أغطية تحمي أصحابها من الإقصاء. وفي الوقت نفسه، يبحث الأفراد عن مظلة اقتصادية ووسائل لتأمين رزقهم، فتصبح العشيرة مؤسسة تمنح الامتيازات وتوزع الفرص، ومن لم يجد سندًا في أصله يفتش عن أصل آخر يراه أكثر جدوى. أما البعد النفسي والاجتماعي، فهو أكثر عمقًا؛ فبعض الأفراد يبحث عن وجاهة مضافة أو مخرج من عقدة شعور بالنقص، فيظنون أن تغيير الانتماء يمنحهم مكانة أعلى ويفتح لهم أبوابًا لم يكونوا مرحبًا بهم فيها، وهنا يظهر فقدان الثقة بالذات وتآكل القيمة الداخلية أمام بريق الاسم.
ومهما كانت المبررات، فإن الظاهرة تحمل أبعادًا أخلاقية واجتماعية خطيرة. فالهوية العشائرية لم تكن مجرد لقب يُضاف إلى الاسم، بل كانت تعبيرًا عن منظومة قيم عرفية قوامها: العهد، الوفاء، الاعتزاز بالانتماء، التمسك بالرحم؛ سياجًا يحمي الفرد من الذوبان، وإطارًا يمنحه معنى الانتماء. وحين تتحول إلى سلعة قابلة للتبادل، فإننا لا نخسر اللقب فحسب، بل نخسر شبكة الأخلاق التي يقوم عليها المجتمع. إنها أزمة إثنية أشبه بانهيار العملة: حين يفقد الاسم قيمته، تتآكل الثقة، ويفتح الباب لفوضى الانتماءات، لتصبح العلاقات مراوغات، والولاءات أوراقًا تُدار بالمصلحة، والرحم مرّة أخرى ضحية لهذا الانزلاق.
وقد يقول البعض: هذه مجرد إعادة تكيف اجتماعي، رد فعل على العولمة وسيولة الهويات. نعم، يمكن للإنسان أن يعيد تعريف نفسه، ولكن بشروط؛ أن يكون التغيير حاملًا لمعنى الارتقاء والتجديد، لا مجرد وسيلة للهروب من المسؤولية أو تسلّقًا إلى وجاهة وهمية. فالتغيير الذي يفرغ الرحم من محتواه ويحوّل الأنساب إلى بطاقات مرور ليس تجديدًا، بل انحدارًا أخلاقيًا واجتماعيًا، يفضي إلى اغتراب الإنسان عن جذوره وأزمته مع الماضي والحاضر معًا: لا يستطيع البقاء في أصله بما يفرضه من التزامات، ولا صياغة هوية جديدة صادقة، بل يكتفي بالانتقال الشكلي بين الألقاب كما يغيّر المرء ثيابه كل يوم دون أن يغيّر جوهره.
ومن هنا، يفرض المجتمع المحلي في تكريت وقفة نقدية وتأملية يكون شعارها: كيف نحافظ على المعنى العميق للهوية العشائرية كقيمة جامعة لا كأداة منفعة؟ كيف نحول الانتماء إلى خيار وفاء لا خيار مصلحة؟ وكيف نتجاوز عقدة الاسم إلى فضاء الإنسان وقيمه الحقيقية؟ إن الهوية ليست قيدًا يمنع التطور، بل جذر يمنع السقوط؛ ومن يفرّط في جذره لن يجد أرضًا يقف عليها مهما بدت الأسماء التي يختارها براقة.
ان الحل يكمن في ثلاثة مستويات: أولاً، إعادة الاعتبار للمعايير العرفية والاجتماعية بحيث تصبح قواعد توثيق الانتماء واضحة وصارمة مع الحفاظ على مكانة الرحم كعهد مقدس. ثانيًا، ترميم الوعي العام بالقيم الحقيقية للانتماء عبر الأسرة والمدرسة ووسائل الإعلام لتعليم الأجيال أن الانتماء ليس ورقة عبور ولا وسيلة مكسب، بل التزام أخلاقي وجزء من تكوين الشخصية. ثالثًا، تمكين الأفراد بالطرق المشروعة للارتقاء الاجتماعي عبر التعليم والعمل والخدمة العامة، بعيدًا عن تداول الهوية كأداة منفعة.
والهدف هو إعادة كرامة الاسم واللقب إلى مكانهما الطبيعي: عهد محفوظ، وجذر ثابت، ومظلة للانتماء، لا بطاقة مرور. حين يتحقق ذلك، يتوقف "اقتصاد الأنساب" عن المضاربة على ذاكرة المجتمع، وتعود الأسماء إلى بيتها الطبيعي: مصدر معنى واعتزاز، لا مجرد توقيع على بطاقة. المسؤولية مشتركة بين العشائر والمجتمع المدني والمؤسسات التعليمية والإعلامية؛ الجميع مدعو لصيانة هوية حقيقية توازن بين الماضي والحاضر، بين الجذر والمستقبل، بين الولاء للمصلحة والمحافظة على الرحم، لتظل الهوية صخرة صلبة في زمن الرياح العاتية، واسم الفرد شهادة على أصله وكرامته، لا مجرد توقيع على بطاقة.
وفي هذا، تكمن العبرة الكبرى ومفادها: أن الهوية ليست قيدًا بل جذر، وأن من يفرّط في جذره لن يجد أرضًا يقف عليها مهما بدت الأسماء التي يختارها براقة. فالأسماء ليست زخرفًا، بل عهد وسيرة، وأي عبث بها يؤدي إلى ضياع كل شيء، ويدخل المجتمع في دورة من الانكسارات المتلاحقة، لا تنتهي إلا بإعادة الاعتبار للرحم واللقب والهوية والمجتمع نفسه.

فيديوات أيام زمان
من القلب للقلب
مقالات متميزة
حكاية صورة
تراث وتاريخ
شخصيات في الذاكرة العراقية
أدب الرحلات
زمن الماضي الجميل
فى ربوع العراق
الطرب الأصيل
الأبراج وتفسير الأحلام
المتواجدون حاليا
883 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع
اخر الاخبار
- رسائل الفريق حردان التكريتي من منفاه في الجزائر الى الرئيس البكر- سيف الدين الدوري
- مطلوب الاعتراف بدولة الاحواز فور اعلانها!
- من ارشيف القسم التركماني في اذاعة الجمهورية العراقية : الاذاعي الرائد سعيد صالح توركمن
- كلاب بلا أنياب
- المجتمع الدولي تسوده شريعة الغاب !
- تفاصيل جديدة حول الغاء منح العراقيين التاشيرة الأميركية
- صدام والنفط .. "الغارديان" تحذر من تكرار أخطاء العراق في فنزويلا
- ميسانية تفوز بلقب أقوى إمرأة عربية ٢٠٢٥
تابعونا على الفيس بوك