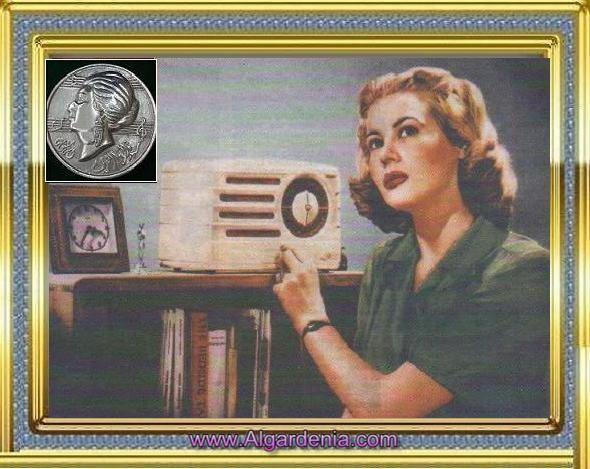زَوَانُ البلد ولا حِنطةُ الجِلب: تأملات في أصالة الأرض وكرامة الجوع
- التفاصيل
- تم إنشاءه بتاريخ الإثنين, 03 تشرين2/نوفمبر 2025 19:15
- كتب بواسطة: ابراهيم فاضل الناصري

إبراهيم فاضل الناصري
زَوَانُ البلد ولا حِنطةُ الجِلب:تأملات في أصالة الأرض وكرامة الجوع
في زمنٍ تُغسَل فيه الحقيقةُ بماءِ الشعارات، ويُباعُ فيه الوعيُ بأكياسِ الطحين، يبقى المثل الشعبي واقفًا كجِذعِ نخلةٍ عنيدٍ في وجه الريح، شاهدًا على صدقِ الفطرة ونقاءِ الأرض: (زَوَانُ البلد ولا حِنطةُ الجِلب).
جملةٌ قصيرة، لكنها تُوزَن بميزانِ الضمير، وتُقاسُ بميزانِ الكرامة.
الزَّوان، وإن كان عُشبًا مُرًّا، فهو ابنُ الأرض الصادقة التي لم تُبدّل طينَها بذهبٍ مستورد؛
أما حنطةُ الجِلب، فهي وافدٌ متأنّق، يحملُ قمحًا في الظاهر، وسُمًّا في الحبوب.
ليس الزَّوان نباتًا هنا، بل رمزٌ للأصالة التي لا تُباع،
وليس القمحُ طعامًا، بل رمزٌ لكل ما يُقدَّم بثمنٍ من الوجوه، ولكل وعدٍ مشروطٍ بفقدان الكرامة.
في القاموس الزراعي، الزَّوان عشبٌ يشبه القمحَ لكنه لا يُؤكل،
أما في القاموس الأخلاقي للمجتمعات، فهو رمزُ البقاء على نقاءِ الأصل ولو بمرارةٍ مؤقتة.
يُفضَّل الزَّوان المحلي، بكل خشونته وقلّته، على الحنطةِ المستوردة مهما بدت ناضجةً ووفيرة،
لأنها مفاضلةٌ بين الأصالةِ والرفاهِ الكاذب، بين الجوعِ والكرامة، بين المرارةِ الصادقة والحلاوةِ المسمومة.
في الحنطةِ المستوردة يسكن وجهُ “الجِلب” — من يُطعِم ليُقيِّد، ويُعطي ليأخذ —
وفي الزَّوان يسكن وجهُ الأرض، تلك التي تُعطي بصدقٍ حتى وهي عاقر.
كم من حنطةٍ أغرتِ الشعوبَ بوفرتها، لكنها جرّدتها من روحها!
امتلأت البطونُ وفرغت الصدورُ من الكبرياء.
لقد أكلنا القمحَ كثيرًا، لكننا نسينا أن نزرعَ الحقل.
وهكذا، تحوّل الخبزُ — الذي خُلقَ رمزًا للحياة — إلى امتحانٍ قاسٍ للضمير:
هل نأكل لنعيشَ أحرارًا، أم نعيشُ لنُطعَمَ أسرى؟
هل نقبل أن يكونَ القوتُ أداةَ إذلالٍ، أم نعيد له معناَه الأول: ثمرةَ الكدّ لا ثمرةَ التوسّل؟
من يقرأ المثل بعين التأمّل، يجد فيه فلسفةً سياسيةً عميقة تختصر مأساة الأوطان:
أن نبقى جائعين بكرامةٍ، خيرٌ من أن نشبعَ في قفص.
«زَوان البلد» هو المعاناة المنتجة،
و«حنطة الجِلب» هي الرخاء الملوّث.
الانتخابُ، والحُكم، والسياسة، والعيش —
كلها تقف اليوم على مفترق الزَّوان والحنطة.
فكم من زوانٍ نبت من تراب الوطن فأثمر وعيًا جديدًا،
وكم من حنطةٍ جاءت على ظهر “الجِلب” فأنبتت فسادًا وذلًّا!
ليس كلُّ من جاء يحمل قمحًا مُخلِّصًا،
ولا كلُّ من لم يُطعِم الناس عاجزًا،
فهناك من يزرع الأرض إيمانًا،
وهناك من يُطعِم الناس خيانةً متقنةَ التغليف.
حين يختار الفلّاح زَوان بلده، فهو يختار نفسه.
وحين يتقبّل الناس مرارةَ ما خرج من أرضهم، فهم يُعلنون ولاءهم للأصل لا للعَرَض.
في الزَّوان مرارةٌ تشبه الصدق،
وفي الحنطة المستوردة حلاوةٌ تشبه الخداع.
الزَّوان هو الذاكرةُ الوطنية — الشيءُ الذي نحافظ عليه حتى وإن لم يُؤكَل —
لأنه من تربتنا، من عرقنا، من وجعنا.
هو تلك العِزّة الخشنة التي لا تُهرّأ بالدهون ولا تُطحَن في مطاحن المصالح.
في عالمنا العربي اليوم، تتكرّر الحكاية بأسماءٍ مختلفة:
نبيعُ الحقيقةَ بحلاوة المصلحة،
ونقايضُ الأرضَ على قوتِ اليوم،
وننسى أن القوتَ بلا كرامةٍ لا يُشبِع أحدًا.
لقد آنَ لنا أن نفهم أن الزَّوان، وإن بدا خسارةً في الحصاد،
فهو ربحٌ في المبدأ،
وأن الحنطةَ التي تأتي من غير عرقنا
هي بدايةُ الجوعِ الحقيقي — جوعِ الروحِ وجوعِ الوطن.
في تكريت، كما في سائر المدن التي أرهقها وعدُ “الحنطة المستوردة”،
ظهر من يزرعُ الهتافَ بدلَ البذور،
ومن يُوزّع القمحَ بدلَ أن يُوزّع العدالة،
ومن يشتري صمتَ الناسِ بكسرةِ خبزٍ، ثم يبيعُ أحلامَهم في سوق الولاءات.
لكن تكريت، التي ذاقت الجوعَ والكبرياء معًا،
تعرف أن الزَّوانَ الذي يخرجُ من ترابها
أكرمُ من الحنطة التي يحملها “الجِلب” على ظهرِ المصلحة.
فكم من حنطةٍ جاءت في شاحناتِ الوعود،
ثم حملت معها وباءَ الفساد وملحَ الانقسام!
وكم من زوانٍ خرج من بين الحجارة،
فأنبت وعيًا جديدًا لا يُسقى إلا بالصدق!
حين قال الأجداد: «زَوَانُ البلد ولا حِنطةُ الجِلب»،
لم يتحدّثوا عن الزراعة، بل عن السيادة.
أرادوا أن نحرُس أرضَنا بأخلاقنا،
وأن نرفُض العطاءَ إذا جاء مسمومًا،
وأن نعيشَ بمرارةٍ صادقةٍ لا بحلاوةٍ مزيّفة.
فالزَّوان الذي ينبتُ من أرضٍ حرّةٍ
خيرٌ من قمحٍ يُنبت على أرضٍ مأجورة،
والجوعُ الشريف أرحمُ من الشبعِ المهين.
احفظوا مرارةَ أصلكم، ولا تستبدلوها بحلاوةٍ زائفة،
وازرعوا قمحكم ولو تأخّر الحصاد،
واسقوا أرضكم ولو بدموعكم،
فإن الزَّوانَ الذي يُنبتُ بوجعكم
سيُثمر يومًا قمحًا حرًّا بلا ثمن.

فيديوات أيام زمان
من القلب للقلب
حكاية صورة
تراث وتاريخ
شخصيات في الذاكرة العراقية
أدب الرحلات
زمن الماضي الجميل
فى ربوع العراق
الطرب الأصيل
الأبراج وتفسير الأحلام
المتواجدون حاليا
1243 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع
اخر الاخبار
- اليوم الدولي للأخوة الإنسانية
- بعد ٦٠ عاماً .. من هو كاتب الأغنية العراقية الشهيرة "الهدل"؟
- كي لا ننسى جرائم أحفاد القرامطة (٧)
- أبناء القذافي .. أين هم؟
- سياسيون وزعماء وأنبياء
- ترامب الصفقة المربحة تحت ظل فرض السلام بالقوة
- كلمات على ضفاف الحدث : في مواجهة غطرسة ترامب : هل أوروبا : بحاجة الى (نهضة حديثة )
- مفاوضات واشنطن وطهران.. ٤ مطالب لن يتراجع عنها ترامب
تابعونا على الفيس بوك